الروائي محمد عيسى المؤدب: شرعت في تفكيك أخطبوط الإسلام السّياسي منذ روايتي الأولى

الرّوائي محمد عيسى المؤدّب: شرعتُ في تفكيك أخطبوط الإسلام السّياسي منذ روايتي الأولى
حوار: أ. وحيدة المي
* الكتابة الأدبيّة ليستْ موهبة فقط، وليستْ حالة وجدانيّة طارئة ، الكتابة صناعة تحتاجُ إلى شروط أهمّها الحرفيّة والشّغف والعمل خارج الضّجيج
* الكتابة هي التزام أوّلا، والالتزام أخرجني من سجون الخوف والتردّد ولعبة اللّاموقف
* شهد البلد في زمن حكم الإسلام السّياسي انتكاسة تدحرجتْ به إلى الجهل والتّخلّف والصّراعات الإيديولوجيّة حتّى صارت تونس مُهدّدة في عمق هُويّتها
* لابدّ أن تكون لنا مواقف لنكتب، وموقفي واضح في رواياتي الأربع المنشورة وروايتي القادمة، أنتصر للحريات العامّة التي تجعل الإنسان إنسانا.

ملاذه الرّواية ، وحقل اشتغاله ” القضايا المُتفجّرة بعد الثورة” وإنسانيةّ الإنسان…بات واضحا من خلال روايته “المعتقل” اشتغاله على تفكيك غول الإسلام السياسي بجرأة…وقد وسّع من زوايا مشروعه ليشمل الجانب الهويّاتي لتونس…يشتغل خارج الضوضاء ، وإذا كتب تُوّج، فنصّه “قنّاص ” بارع للجوائز الوطنية والعربية التي قال إنها لا تعنينيه “زمن الكتابة، لكنّه ينتظرها بعد النّشر”… باتت كتاباته تثير جدلا في السنوات الأخيرة…وبات أكثر حكمة في الردّ على ما وصفه ب “هرسلة الكاتب للكاتب” الروائي محمد عيسى المؤدّب جمعنا به هذا الحوار.
– إنطلقتَ بالقصّة و أقمتَ في الرّواية وتميّزت، هل يعني ذلك أنّك اخترت وجهتك النّهائية؟
– عندما بدأت مغامرتي في كتابةِ القصّة القصيرة لم أكن أنتظرُ يومًا أن أنقطع عن الفنّ العظيم المُسمّى قصّة قصيرة لأتّجه إلى كتابة الرّواية. أنا مدين للرّوسيّيْن مكسيم غوركي وأنطوان تشيخوف، فقد قادتني الصّدفة إلى أعمالهما العظيمة بمكتبة كتب قديمة بنهج زرقون بالعاصمة، وانطلاقًا من ذلك شغفتُ بالقصّة القصيرة، وزاد هذا الشّغف أيّام دراستي عند أستاذي الجليل توفيق بكّار بكليّة الآداب بمنّوبة، فقد كان يدرّسنا قصص علي الدّوعاجي في مسألة القصّة القصيرة. حقيقة كان ساحرًا وهو يُحلّل ويستنطقُ الدّرر. أعتقدُ الآن أنّ الرّواية سجنتني في عوالمها ولا أعتقدُ أنّي سأغادرها في تجربة الكتابةِ.
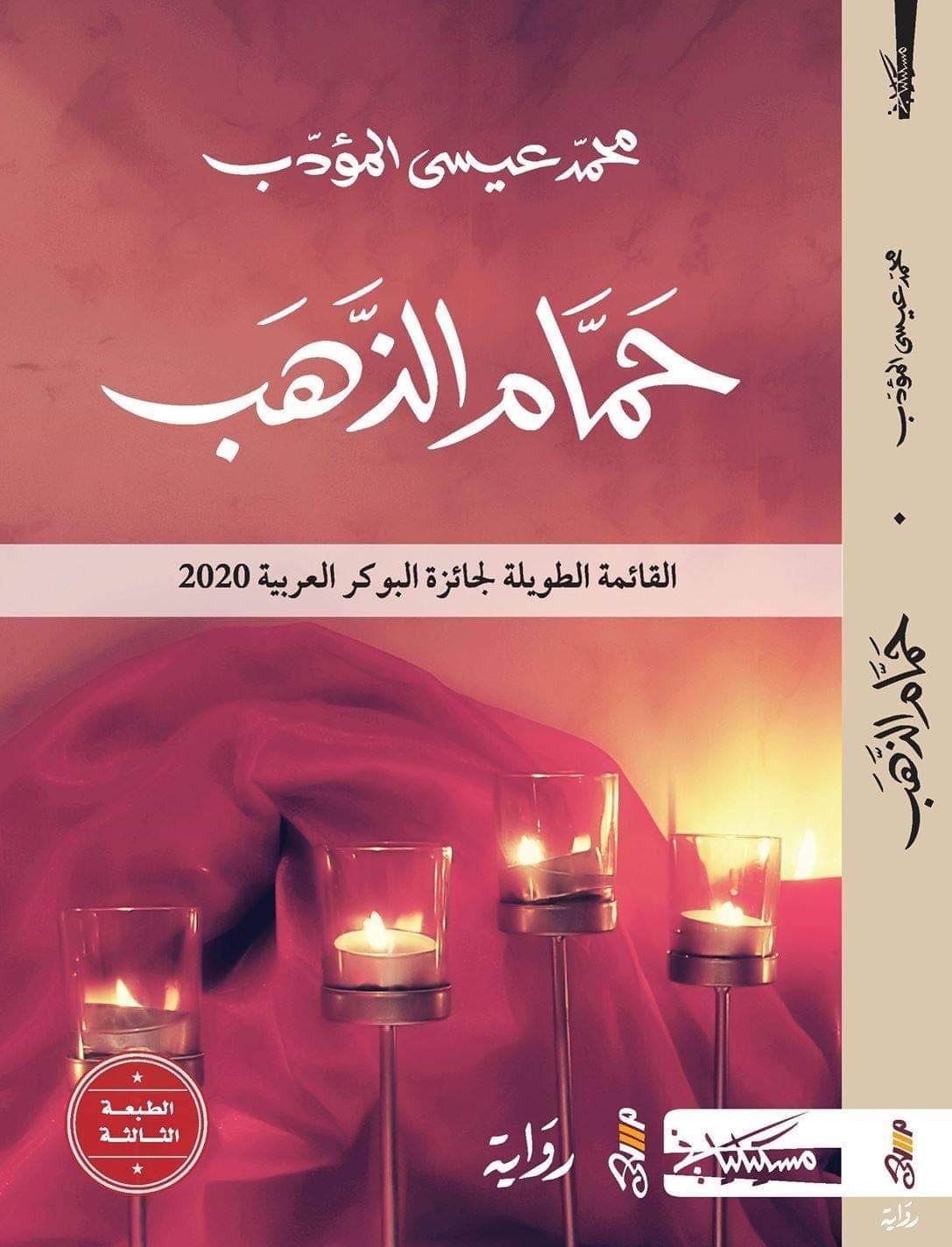
– تركت كتابة القصّة ما يزيد عن ربع قرن، هل كانت مجرّد محطّة للعبور إلى ما هو أشمل؟
– لا، أبدًا صديقتي وحيدة المي، لم تكن القصّة القصيرة مجرّد محطّة عبور، الأمر مُرتبطٌ أساسًا بتغيّر القناعاتِ وتطوّرها في ظلّ مُتغيّرات العالم، ومُرتبطٌ بمشروع الكتابةِ أيضًا، أعتقدُ أنّ القضايا المُتفجّرة بعد ثورة 14 جانفي 2011 في تونس لا يُمكن أن تستوعبها القصّة القصيرة، لذلك كانتْ الرّواية ملاذي.
– من “عرس النار ” إلى “حذاء إسباني”، ما الذي تغيّر؟
– تغيرّت القناعات وجماليّات الكتابة، تلك الجماليّات التي تتطوّر كلّ لحظة في عالم الكتابة العجيب. والأهمّ أنّه كلّما أتعمّق في هذه العوالم السريّة أزدادُ قناعة أنّ الكتابة الأدبيّة ليستْ موهبة فقط، وليستْ حالة وجدانيّة طارئة كما يعتقدُ الشّعراء، الكتابة صناعة تحتاجُ إلى شروط لتطويرها ولعلّ أهمّها الحرفيّة والشّغف والعمل خارج الضّجيج.
– ما الذي يجعل الكاتب ينحاز إلى جنس إبداعي دون آخر، وما رأيك في أنّ من يكتب الرّواية يتميّز بنفس سرديّ طويل عكس كاتب القصة؟
– الانحياز إلى جنس أدبي مّا مأتاه اختيارات جاءتْ بها الصّدفة ثمّ تدعّمتْ بعمق الاطّلاع والممارسة وقد تكون الأسباب مُرتبطة بالتّكوين المعرفي والعلمي للكاتب، ومع ذلك قناعتي أنّ المبدع اليوم، في مرحلة ما بعد الحداثة، عليه أن يكون مُتشبّعًا بكلّ الأجناس الأدبيّة، باعتبار أنّها تتجاور وتتفاعلُ في ما بينها رغم مُحافظة كلّ جنس أدبي على أعمدته ومقوّماته وجماليّته المخصوصة.
من يكتب الرّواية يمتلك فعلا نفسًا سرديّا طويلا على عكس كاتب القصّة، لكن علينا أن نفهم ما معني نفسًا طويلًا، وبرأيي المقصود هو سعة البحث والمعرفة الغزيرة المُحيّنة والدّأب على القراءة وتطوير آليات الكتابة وجماليّاتها حتّى يتطوّر ذلك النّفس السّردي من نصّ إلى آخر وإلا بقي الرّوائي يجترّ نفس العشب ما يُسبّب عدم تطوّر التّجربة وبالضّرورة موتها.
دخلت عالم الرواية بقوّة وأحرزت روايتك “جهاد ناعم ” الكومار الذهبي وكانت من صميم أوجاع ثورة14 جانفي في تونس.
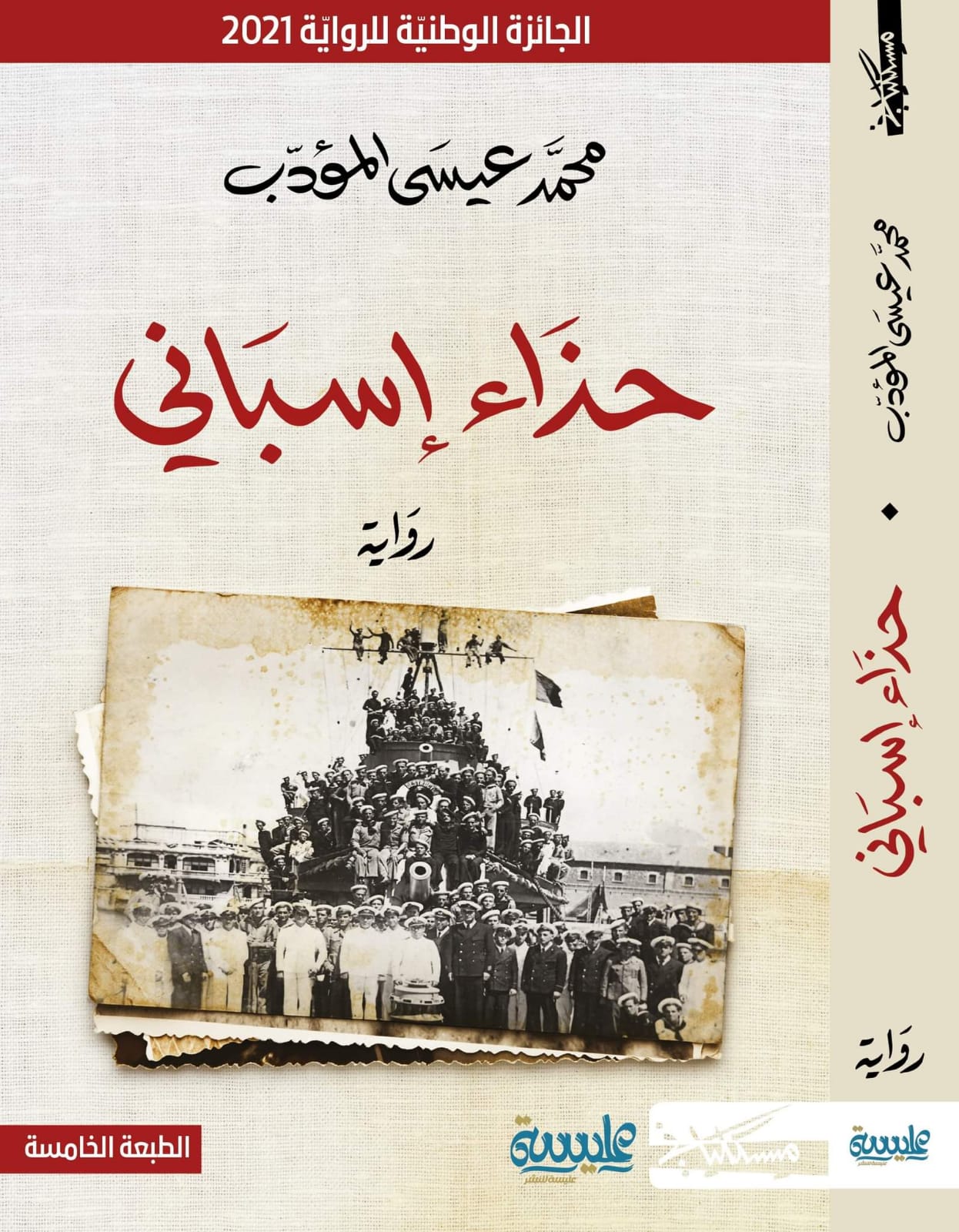
بعد نشر روايتي الأولى ” في المعتقل ” سنة 2013 عن دار الأطلسيّة فكّرتُ في مشروع روائي أسردُ فيه هويّة تونس، وتتنزّل رواية “جهاد ناعم” في هذا المعنى، فقد فكّكتْ غول الفكر الإخواني أو ما يُسمّى بالإسلام السّياسي وسردتْ وقائع من أوجاع بلدي بعد ثورة 14 جانفي، أوجاع الشّباب الحالم بالحريّة والشغل والكرامة فإذا به يهربُ عبر المتوسّط في قوارب الموت، وإذا به يُسفّر للجهاد في سوريا والعراق وليبيا، وإذا بالبلد يُرمى بين فكّي تنّين التطرّف والإرهاب والاغتيالات السّياسيّة.
تحتاج كتابة الواقع مسافة حياد بين الكاتب وما يحدث، لكنك عرّيت الإسلام السياسي وأجندا تجّار الدين، وكنت مغامرا في طرق هذا الباب الخطير؟
وهل كان الشّابّي مُحايدًا زمن الاستعمار؟ وهل كان المسعدي مُحايدأ زمن بناء الدّولة؟ يا سيّدتي العزيزة تُلغى مسافة الحياد بالنّسبة للكاتب عندما يُهدّدُ الوطن في حاضره ومُستقبله، في هُويّته ومُكتسباته، وفي الحقيقة فإنّي شرعتُ في تفكيك ما يُسمّى بأخطبوط الإسلام السّياسي منذ روايتي الأولى ” في المعتقل”، ففيها تسريد للفكر الإخواني وللسّلفيّة برأسيها الوهّابي والجهادي، أمّا رواية ” جهاد ناعم” فكانت أكثر جرأة في فضح تجّار الدّين الذين انقضّوا على البلاد انقضاض الوحوش على فريسة. للأسف في أيّام الفراغ السّياسي والقلق الاجتماعي والرّغبة في الانتقام من رموز النّظام السّابق تسلّم الإخوان تونس بعقليّة غنيمة حرب لا بروح وطنيّة إصلاحيّة. في رواية “جهاد ناعم” تسريد لوقائع الجشع والنّذالة والفساد والجريمة التي عمّقتْ أزمة تونس هوويًّا وسياسيّا واجتماعيًا، بل شهد البلد في زمن حكم الإسلام السّياسي انتكاسة تدحرجتْ به إلى الجهل والتّخلّف والصّراعات الإيديولوجيّة حتّى صارت تونس مُهدّدة في عمق هُويّتها. عرفتْ تونس زمن الإسلام السّياسي عشريّة سوداء وكابوسيّة، عشريّة الجشع والفساد والتّجارة بالدّين والتطرّف والإرهاب والاغتيالات السياسيّة، حتّى صرنا لا نعرفُ بلدنا، فقد صرنا غرباء داخله.
– تناولت الأسطورة في رواية “حمام الذهب ” وعدت بالقارئ إلى متعة الخرافة والمخيال الشعبي، كيف تستقي قادح رواياتك؟
– فعلا، رواية ” حمّام الذّهب ” سليلة خرافة “حمّام الذَّهَب” القريب من “سيدي محرز” في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، خرافة ظلّت عالقة بالذّاكرة الجماعيّة والتراث الشفويّ الشعبيّ، ولئن كان سحر الخرافة في البحث عن الذّهب فإنّ سحر تسريد تاريخ يهود القرانة أعمق من ذلك بكثير.. لم أكتفِ بمتعة الخرافة أو المخيال الشّعبي لأتجاوز ذلك إلى البحث عن الهويّة التونسيّة التي تشوّشتْ بعد الثّورة مع الظّلاميّين. ولعلّ البحث والحفر في الأمكنة هو ما يُتيح القادح المُناسب للرّواية، القادح الذي يجعل كلّ رواية مُختلفة عن سابقتها في هندستها ومضمونها.
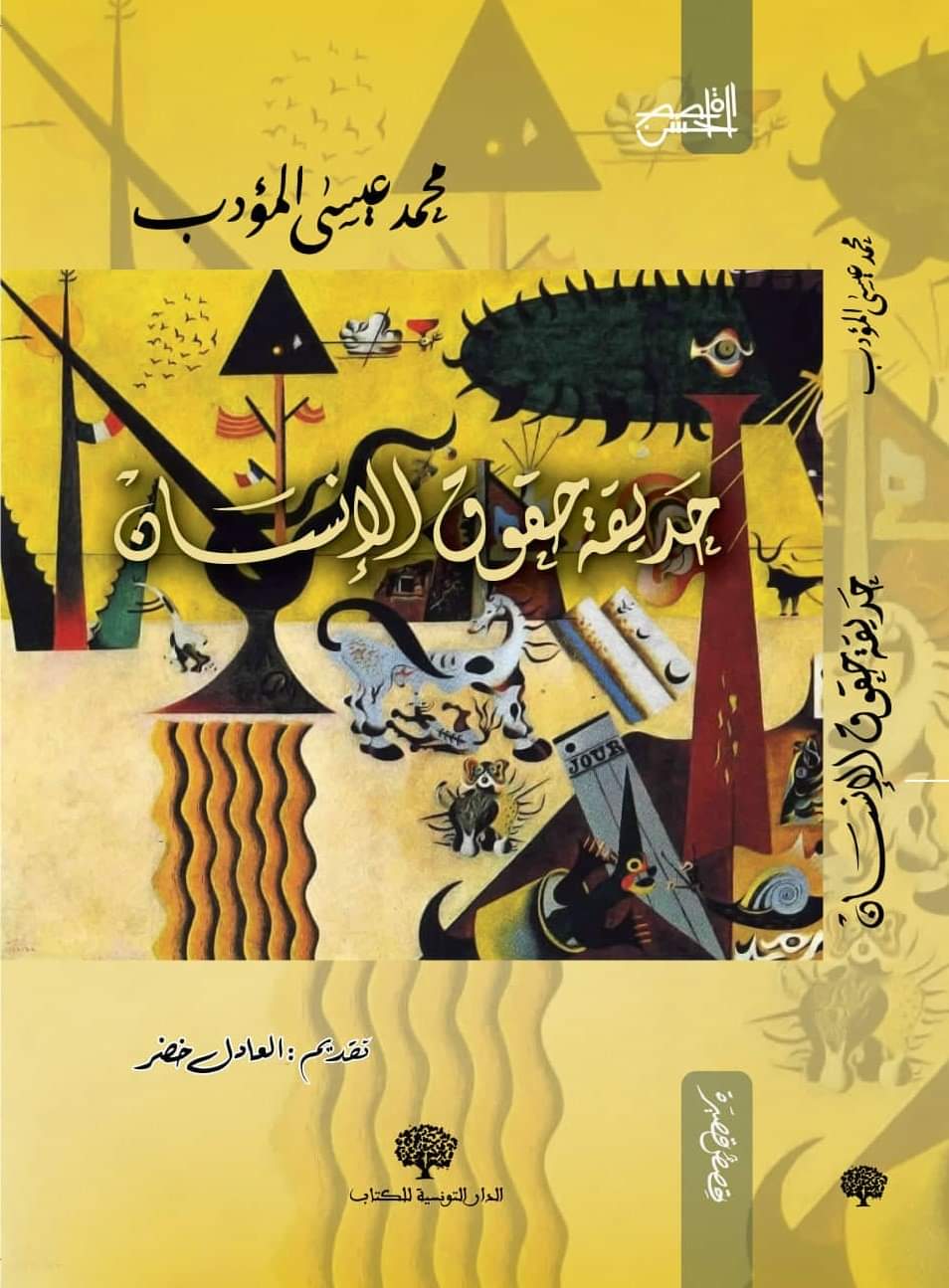
– وسّعت كتابتك الإبداعية بالتّنقيب في حقل جديد مثل مسألة الهويّة والديانات والتاريخ في حمّام الذّهب وحذاء إسباني ، ماذا وراء هذا البحث المستمرّ في تجديد تيمات سردك؟
– تجديد تيمات السّرد يعود بالأساس إلى المشروع الذي حدّدته سلفًا، وهو يخصّ كما أشرتُ الهويّة التّونسيّة، وهي هويّة التعدّد والتنوّع والاختلاف. جسّمت الحمولات التاريخيّة والتراثيّة والدينيّة والاجتماعيّة لمدينة تونس في رواية حمّام الذّهب الحوار والتّعايش بين الإسلام واليهوديّة وبين ثقافتين يحملان نفس الهموم والمشاغل والانتظارات، فمثلما حضر جامع الزّيتونة والكتاتيب ومقام سيدي محرز وغيرها حضر الكنيس اليهودي في الحفصيّة والمدرسة اليهوديّة ومباني اليهود وهو ما يبرز حضور المدينة كفضاء حيّ متّقد بالمشاعر وبرغبات استعادة ذلك الماضي والانتصار لما يحمله التّراث الإنساني من دلالات إنسانيّة رغم ما صاحبه من تجارب مؤلمة وقاسية من قبل النّازيين والمتعصّبين دينيّا واجتماعيّا من المسلمين واليهود على حدّ سواء. أمّا أحداث رواية “حذاء إسباني” فتدور في زمن الحرب الأهليّة الإسبانيّة وما تلاها من أحداث وفواجع، وفي زمن الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسيّة والحرب العالميّة الثّانية وحرب 48 وما بعدها. تلتقي شخصيّات الرّواية من ثقافات وأديان مختلفة، مسيحيّة ومُسلمة ويهوديّة لتروي ما دُوّن في الكنّش الأحمر من سيرة الحرب والمقاومة والحبّ. وإذا انشغل التّوثيق أيّام الحرب بإحصاء أعداد الجثث والجرحى فإنّ الرّواية جمّعتْ ألبوم الصّور ونبشت عن القصص التي حوّلتْ آلام الحرب إلى انتصار على الكراهيّة والاضطهاد وإلى حوار حضاري خارج عن روزنامة العلاقات التقليديّة بين الشّمال والجنوب أو بين أوروبا وشمال إفريقيا.
– أثرت في أعمالك الأخيرة مسألة الهوية والديانة، واستدعيت حضور شخوص يهودية، من حمام الذهب إلى حذاء إسباني، هل هو السياق السردي العام يفرض ذلك أم ماذا؟
– ماضي مدينة تونس هو ذلك الماضي المشترك والحميمي بين الثقافات لذلك طرحت في رواية حمّام الذّهب الأسئلة التّالية: لماذا اختلفنا الآن وتصدّعنا وأصبحت الكراهيّة شائعة في لغتنا وثقافتنا وسلوكنا؟، لماذا نكرّس الإلغاء في نظرتنا إلى الآخر ومن المتسبّب في ذلك؟ أهي العولمة؟ أم السّياسة؟ أم الهشاشة النفسيّة في هذا الواقع المتحوّل والمتأثّر بحركات التطرّف التي ما فتئت تتغلغل في مدارسنا ومنازلنا وشوارعنا؟ يُخبرنا التّاريخُ أيضا أن تونس احتضنتْ الكثير من اللّاجئين، بدْءًا من الصّرب 1817 والرّوس 1919 والإسبان 1939 والفلسطينيّين 1982، فلأجل ما احتفظت به الذّاكرة ولأجل السّياق السّردي تحضرُ الشّخصيّات مُتعدّدة ومُختلفة، مُسلمة ويهوديّة ومسيحيّة في أعمالي الرّوائيّة. لقد عرفت مدينة تونس منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة حضارة تعاقب العديد من الدّيانات والثقافات، وعُرفت العلاقات بالمحبّة والتآزر بعيدا عن التطرّف والحقد الاجتماعي رغم الحالات الشاذّة التي حدثت خلال حرب الأيام الستّة، فقد تجاور جامع الزّيتونة وجامع سيدي محرز مع الكنيس اليهودي في الحفصيّة قديما والكنيس اليهودي في شارع الحريّة ومع الكنائس المسيحيّة في شارع الحبيب بورقيبة وقرطاج بيرصا وغيرهما، كما تجاورت العائلات المسلمة مع العائلات اليهوديّة والعائلات المسيحيّة فكانت الأجواء عامرة بالوئام والاحترام والتّعايش الإنساني الذي ينبع من رغبة في توحيد ربّ العالمين.. ويكشف المعمار أيضا ذلك الانصهار الحضاري بين الثّقافات( أندلسيّة وعثمانيّة وأروبيّة وغيرها) حتّى أصبح المعمار بعد ذلك عجينة تونسيّة بثقافات وحضارات متعدّدة.
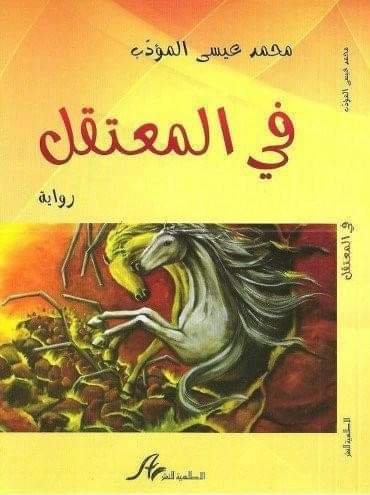
– ألا ترى أن طرْق هذا المجال- الكتابة عن اليهود – وما يسمّى بالأدب الكوني غير المعترف بالعرق والدين والهويّة هو من مفاتيح الحصول على جوائز عربية وعالمية هامّة؟
– الكتابة هي التزام أوّلا، والالتزام أخرجني من سجون الخوف والتردّد ولعبة اللّاموقف، لابدّ أن تكون لنا مواقف لنكتب، وموقفي واضح في رواياتي الأربع المنشورة وروايتي القادمة، أنتصر للحريات العامّة التي تجعل الإنسان إنسانا، تجعله حرّا وعاشقا للحياة، أنا مع المساواة بين الرّجل والمرأة ومع حقوق الإنسان بدءا بحقوق الطّفل، ومع التعدّد والتنوّع ، ومع التّعايش والتّسامح ومع السّعادة وبطبيعة الحال أنا ضدّ التطرّف والإرهاب والمتاجرة بالدّين، وضدّ الإقصاء والعنف والفوضي، وضد التحرّش والهرسلة والفساد وشتّى أشكال الاستغلال.. من السّهل أن نكتب لكن من الصّعب أن نقنع الآخر بما نكتب، لذلك فإنّ الرّواية الحديثة تستند إلى خطاب حجاجيّ متعدّد يتجاوز الخطاب العفوي المقتصر على عفويّة الوجدان وسطحيّة الموقف، هذا أوّلًا، ثانيًا، يا سيّدتي، لقد صدّعوا رؤوسنا بالتدخّل في المواضيع التي ينتقيها الكاتب، مُتّهمين إيّاه بالتّطبيع وتبييض اليهوديّة وبالطّمع في الحصول على جوائز وغيرها وغيرها، أليس في ذلك هرسلة للكاتب ومُحاصرة لحريّة التعبير والإبداع؟ طيّب أعلمك، على سبيل الذّكر، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعتني في مناسبتين، صيف وخريف 2022، من دخول الأراضي الفلسطينيّة للمشاركة في ندوة الرّواية العربيّة وفي معرض فلسطين الدّولي للكتاب. الجميع يهرسلون الكاتب وأغلبهم من الكتّاب، إن اتّفقنا على تسميتهم كتّابًا، وللأسف قلّة قليلة تقرأ ما يكتب لمعرفة حقيقة مواقفه.
– كلما شاركت في مسابقة إلا وتوُّجت، من الكومار(2017)، إلى المعرض الدولي للكتاب(2020)، إلى الجائزة الوطنيّة في الرّواية(2021) وصولا إلى بلوغ القائمة الطويلة في جوائز عالمية هامّة، ما سرّ هذا النجاح؟
– بدايتي أيضًا كانتْ مع الجائزة الوطنيّة لأدب الشّباب في القصّة القصيرة عن مجموعتي القصصيّة الأولى ” عرس النّار”. في الحقيقة، ما أُفكّر فيه دومًا هو الإضافة التي يمكن أن يقدّمه كتابٌ مّا، كتاب جديد أعني، فأنا أكون مشغولًا بأدقّ التّفاصيل، الشّكل، المضمون، النّشر وتفاصيله، التّوزيع، الإعلام وغيرها من الحيثيّات التي تهمّ كلّ كتاب جديد يمكن أن أضيفه للمكتبة التّونسيّة. مسألة الجوائز لا تعنيني زمن الكتابة، لكنّي أنتظرها بعد النّشر، فالجوائز مهمّة جدًا في حياة المبدع، وفي جميع الفنون، القارئ في الغالب لا يقتني إلّا الكتب المتوّجة، والنّاقد لا يهتمّ إلّا بالأعمال الفائزة والإعلام هو الآخر لا يحتفل إلّا بالكتّاب الحائزين على جوائز، تلك هي اللّعبة، أو الحقيقة، فكيف ننكر قيمة الجوائز المحليّة والعربيّة اليوم؟
– أنت من أبناء صاحب الجبل بالهوارية، تعيش بين جنّتين، الجبل والبحر، من هنا إذن تستقي قصص الحب الممتعة وجمال لغة السرد؟
– أجل، منطقة الهواريّة حباها الله بطبيعة ساحرة، وبالإضافة إلى جنّتيْ الجبل والبحر هناك جنة ثالثة هي غابة دار شيشو الممتدّة من منطقة صاحب الجبل إلى حمّام الأغزاز وقليبية. مع هذا الثّلاثي السّاحر أحاور المعنى في هدوء تامّ.
– لم تكن الطريق معبّدة منذ الطفولة، ومع ذلك نجحت وأنت اليوم من الأسماء الروائية الهامّة، كيف قفزت على المستحيل؟
– في الواقع، اكتشفتُ الكتاب بشكل متأخّر، وتحديدًا في مكتبة معهد عزيز الخوجة بقليبية، فأيّام دراستي الثّانويّة عرفتُ أنّ هناك رواية ،وأنّ هناك قصّة قصيرة، فمنطقتي الريفيّة، صاحب الجبل أعني، كانت محرومة من كلّ شيء تقريبًا، وكان لابدّ من المُقاومة، لكن أجمل ما حدث أنّي اكتشفتُ أيّام دراستي الثانوية بقليبية مكتبة بنهج زرقون بالعاصمة كانت تبيع كتبًا قديمة ساحرة في فنّيْ القصّة القصيرة والرّواية وبكلّ اللّغات.
– تشتغل في صمت وحياد تامّ عما يحدث في الساحة الثقافية والسياسيّة، لكنّ نصوصك ضاجّة وصاخبة، لماذا تمنح النص صوتك؟
– فعلا، لا أعرف الضّجيج والجرأة والموقف والالتزام إلا مع رواياتي، إلّا مع شخصيّاتي التي تعيشُ معي زمن الكتابة وبعده، قد نعرفُ صراعات ومُشاحنات، وهذا مهمّ في الكتابة، حتّى لا تكون الشّخصيّات نسخًا مُشوّهة منّي.
– هل ننتظر الجديد؟
– طبعًا، قريبًا تصدر روايتي الجديدة ” بلاصْ دِيسْكَا” عن منشورات ميسكلياني” وهي جهد قرابة ثلاثة سنوات بحثًا وكتابةً.





