مقابلة مع الدكتور أمجد الزعبي

مقابلة مع الدكتور أمجد الزعبي

حاوره سليم النجّار
– ثقافة العزلة اليهودية مرتبطة بالديانة اليهودية.
– عاش اليهود عبر تاريخهم في حارات خاصّة بهم.
– سلوكهم الاقتصادي واد في عزلتهم.
– رغم التضحيات العربية الكبيرة مازالت معتمدة على الفعل وردة الفعل.
– شكلت كتابات عبد الوهاب المسيري حالة جديدة في التعاطي مع الحركة الصهيونية.
– لدينا تلموذان: تلموذ كتب أيام السبي البابلي والثاني أثناء السبي الروماني.
المقدمة:
يُحكى أنّه: في ليلةٍ من ليالِ العذاب، العربي الفلسطيني، وقد استبدّ عنت السُّهاد، وتحكم في إغفاءةِ الجفون وخاصم الكرى عيون الليل، وغَلفَ جلاله سكون.
والكون يُجللّه خشوع السحر، كأنّه ينتظر ضيفًا عزيزًا، يكونُ سلوى للروح، وبلسمًا للقلب؛
وفي لحظة: أطلَّ الضيف
– من هو؟
– إنّه طيف الأردن
– ما أعزّه من ضيف.
ترقب سكون اللّيل، سكونًا عمَّ المكان، سكونًا سكن في مقر رابطة الكتّاب في اللوبيدة.
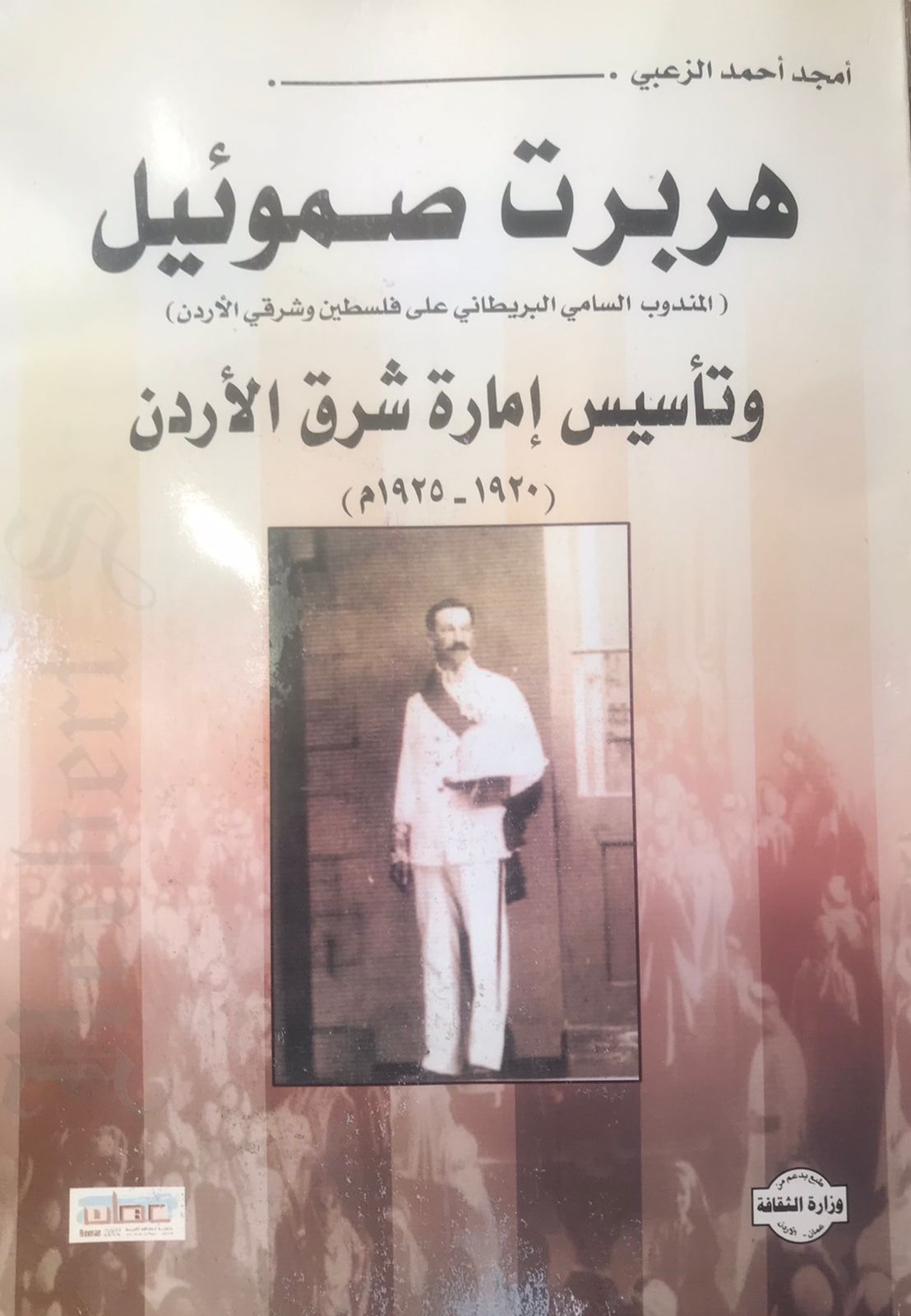
بدأ النسيم يتسلّل للمكان، ساريًا ملهوفًا لشجرة النارنج التي تفوح في حدائق عمّان.
جلست مع الضيف – في حديقة الرابطة الكتاب.
إنه د/ أمجد الزعبي أستاذ مشارك (تاريخ العالم الحديث والمعاصر- أوروبا) – في جامعة فيلادلفيا، له العديد من الأبحاث التي نشرت في مجلات محكمة، “الاستشراق والتغلغل الألماني في الدولة العثمانية، ودراسة في وظائف الاستشراق الألماني في الربيع الأخير من القرن التاسع عشر؛ وله العديد من المؤلفات نذكر منها “هربرت صموئيل -(المندوب السامي البريطاني على فلسطين وشرقي الاردن) و(وتأسيس إمارة شرق الأردن- ١٩٢٠ – ١٩٢٥) صادر عن وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة عمّان؛ وحاورناه عن الحركة الصهيونية، وبادرناه بالسؤال الأوّل:
كيف تشكلت ثقافة العزلة عند اليهود؟
إذا كان من غير المسموح به بثّ أفكار عاطفية انفعالية تفاؤلية بقرب انهيار “إسرائيل” وزوال غزوها الثقافي للمنطقة العربية، فمن غير المسموح به كذلك التعامي عن شرح ثقافة العزلة اليهودية، والتي لها دور غير قليل في نشأة مشروعهم الإحلالي الاستيطاني في فلسطين، فثقافة العزلة اليهودية مرتبطة بالديانة اليهودية نفسها، فهي ليست ديانة تبشيرية، أي أنّها لم تسعَ إلى نشر الدين لغير اليهود. وبهذا التطوّر المغلق نشأ كتاب مقدس موازٍ للتوارة وهو التلموذ، ولدينا تلموذان، تلموذ شرقي والذي كتب أثناء السبي البابلي، وتلموذ غربي كتب أثناء السبي الروماني، وكلاهما يتّفقان على حالة الانغلاق والتمييز العنصري الذي مارسه اليهود عبر تاريخهم ضدّ الآخر، والمقصود بالآخر غير اليهودي، “الأغيار”، ولم يتوقّف هذا التمييز العنصري عن كلّ من يختلف عن ديانتهم، بل إلى أنفسهم أيضاً، فهناك يهود سفرديم، أي يهود الشرق، واليهود الأشكناز؛ أي يهود الغرب الذين تشكّلوا من الخزر، والتي انهارت إمبراطوريتهم، وانتشروا بعد هذا السقوط في شكل خط ممتد من بحر الخزر حتّى بولندا.
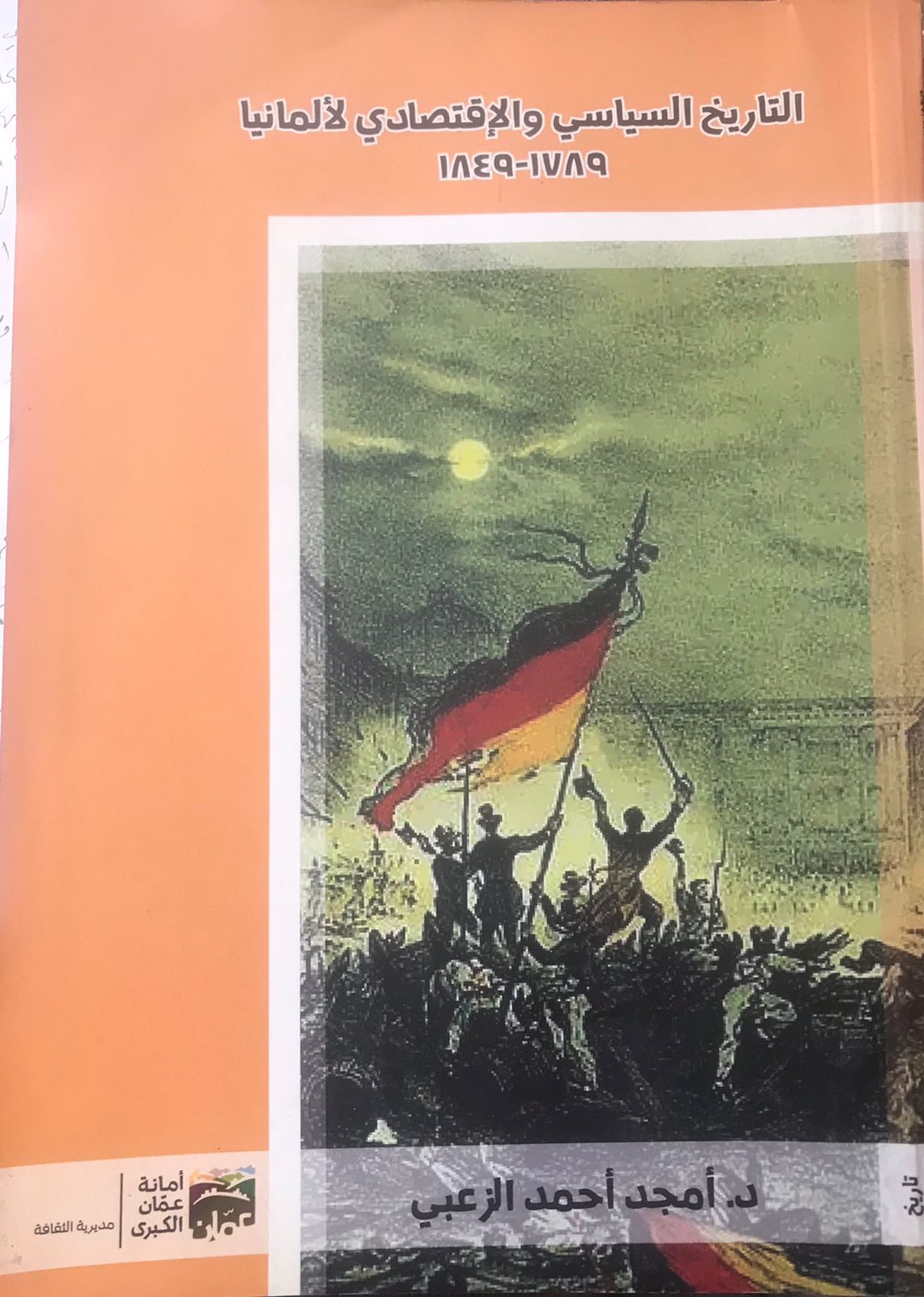
مارس اليهود الأشكناز داخل المجتمعات الغربية التي عاشوا بين ظهرانيها، ما يميزهم عن غيرهم، ونجحوا في مهنة السمسرة والربا وبعض الحرف اليدوية، لأنّ في ذلك الوقت كانت المجتمعات الغربية تنظر إلى الحرف اليدوية وبعض المهن الاقتصادية كما ذكرنا قبل قليل: السمسرة والرضا بدونية، وجرّاء هذا السلوك الاجتماعي اليهودي، أصبحوا منبوذين داخل المجتمعات الغربية المسيحية، والنظرة لهم عدائية، كما أنّ قناعة المسيحيين بأنّهم- أي اليهود يحملون جرم دم المسيح عليه السلام. كلّ هذه الرؤى لهم من قِبل المجتمعات التي عاشوا فيها، زاد في عزلتهم وانغلاقهم. وفي عصر النهضة الأوروبية التي انتشرت فيها فكرة المساواة، التي ناضل الأوربيون عبر ثورات لا حصر لها من أجل تحقيقها، كان من تداعياتها حصول اليهود على المساواة، لتنطلق الطاقات اليهودية، وتشارك في النهضة، وخاصّة أنّهم يملكون المال، والخبرة الحرفية التي كانت المادة الأولية للثورة الصناعية.
لا شكّ أنّ موضوع المقابلة ذو بعد تاريخي يغري المحاور بالركون للسؤال الثاني:
كيف حافظوا اليهود على يهوديتهم رغم المتغيِّرات العالمية التي هزّت العالم؟
للإجابة على هذا السؤال، مرتبط بالمسألة اليهودية نفسها التي نمت وترعرعت في المجتمعات الغربية، وتحديدا ما بعد الدولة القومية الأوروبية؛ فقد كانوا روّادًا في تحرير الفكر من الدين، والأمثلة كثيرة ممكن نذكر شترواس الذي كتب عن حياة يسوع، وامتلك القدرة على نقد العهد القديم والجديد، وأعتقد أنّ أصوله اليهودية جعلته أكثر تحررا في نقد الكتاب المقدّس. ولذلك كانت المسألة اليهودية متعلِّقة بموقع اليهود المنعزلين في كلِّ المجتمعات التي عاشوا بها، رغم مشاركة بعضهم في النهضة الأوروبية، إلاّ هذه المشاركات لم توثر على الوعي والمفاهيم الجمعية لليهود، بل على العكس تماماً، استثمر اليهود هذه المشاركات في تحقيق مشروعهم في إقامة دولتهم في فلسطين بتعبير دقيق تمّ حال المسألة اليهودية على حساب العرب، وهذه من المفارقات التاريخية، وهي أنّ عصر النهضة الذي طالب بالمساواة، غفل عن قصد وعمد، أنّ للعرب لهم الحقّ في مساواتهم كباقي البشر والحفاظ على أرضهم وتاريخيهم، بالفعل إنّها مفارقات مؤلمة، ما زلنا كعرب ندفع ثمنها ليومنا هذا.
شكّل الغزو الثقافي جزءاً أساسياً من مشروع استعماري قديم يرقى إلى بدايات السيطرة الأوروبية على الوطن العربي بعد أنْ مهّدت له أوربا بأشكال متنوعة من وسائل التفكيك الداخلي للسلطنة العثمانية أبرزها المعاهدات التجارية وحماية الأقليات والمِلل والأقليات الطائفية، أمام هذا الواقع التاريخي الاجتماعي يحضر السؤال الثالث، كيف استفادت الحركة الصهيونية من هذا الواقع؟
بالتأكيد الحركة الصهيونية استثمرت هذا الواقع لمآربها، خاصّة أنّ هناك حالات اجتماعية لا بد من ذكرها، فكانت هناك حارات خاصّة بالطوائف، وعلى سبيل المثال في دمشق كان هناك حارة لليهود، وحارة الأرمن، ولم تقتصر الحياة في الحارات على الطوائف، بل كان هناك حارات للحرف، فكلّ حرفة لها حارة خاصّة بها. لذلك لم يعانِ اليهود في المجتمعات العربية كما عانوا في المجتمعات الغربية. وكما نقول عن العرب المسيحيين، والعرب السنة والعرب الشيعة، كنا نقول العرب اليهود. وفي إشارة أخيرة فإنّ العداء لليهود يشكِّل مصلحة صهيونية تساوي التعاطف مع الحركة الصهيونية في أوروبا.
ليس هناك شكل واحد للغزو الثقافي الصهيوني للوطن العربي إذ تمّت عملية الاختراق بأشكال مختلفة وتبعا للمراحل التاريخية ولحاجة المشروع الصهيوني، هذا الأمر يستدعي سؤالا رابعا: مَن المفكرون العرب الذين واجهوا هذا الغزو؟
لا بدّ من القول إنّ الكاتب والمفكر العربي المصري عبد الوهاب المسيري، شكّلت دراساته عن الحركة الصهيونية حالة متقدّمة وجديدة في التعاطي، فهو مؤسِّس لوعي كبير داخل النخب العربية، والجمهور العربي أيضاً على حدّ سواء، فالمسيري ربط خطورة المشروع الصهيوني على القطري العربي والقومي، معتبرًا هذا المشروع خطرًا سرطانياً على الكلّ العربي.
عرفت الحركة الصهيونية، قبل تجّسدها في دولة “إسرائيل” وبعد ذلك يأتي سؤال خامس كيف حصل ذلك؟
الإجابة على هذا السؤال يرتبط بدرجة كبيرة جدًا بالمشروع الصهيوني الذي تحدّدت أُطره وقواعده السياسية في مؤتمر بال بسويسرا العام ١٨٩٧م، ولتقرأ تنفيذ القرارات الصادرة بالتتابع كأنّنا نتحدّث عن مشروع مرحلي أنجز الجزء الأوّل بتصريح بما عُرف بوعد بلفور المشؤوم العام ١٩١٧ وجزئه الثاني بالضمانات الدولية، وفي قانون الانتداب البريطاني الذي كان في ديباجته تصريح بلفور، وتوج بقرار التقسيم وإعلان ميلاد الكيان الصهيوني، في حين أنّ المشروع العربي لم يرتقِ لهذه التحديات التي تعرّض لها، وهذا العجز له أسبابة الموضوعية، فكان الاستقلال العربي عن الاستعمار الأوروبي بأشكاله وهوياته السياسية والإثنية، مرافقاً بنفس الفترة لقيام المشروع الصهيوني، يُضاف إلى ذلك، أنّ الجيوش العربية التي دخلت تواجه” الصهاينة” في عام ٤٨، والتي عرفت بعام النكبة، لم تكن حتى ولو رقمياً توازي عدد جنود العصابات الصهيونية، ولا ننسى الدعم غير المحدود من بريطانيا لتلك العصابات، الأمر الذي أدّى إلى هزيمة العرب، ولا ننسى أنّ فشل النظام السياسي العربي آنذاك كان له دور في عدم قدرة المواجهة مع المشروع الصهيوني، كلّ هذه الأسباب مجتمعة أدّت إلى كارثة ٤٨، والتي تجلّت بأبشع صورها في قيام دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية.
وفي الختام لا بدّ من التصدي، بكل الوسائل الممكنة، لهذا المشروع الصهيوني، داخل وطننا العربي، وبالتالي تقطع الطريق على تزيف تاريخنا، ماذا تقول:
ما قدّمه الشعب العربي من تضحيات جسام، ما زال معتمدًا على الفعل وردّة الفعل. وما سُمّيَ بالطلائع لم تصل إلى مرحلة القدرة على الإيمان الكامل بقدرات الشعب العربي على التضحية، لتؤكّد حتمية زوال هذا الكيان. أقول دائماً إنّ عنجهية الصهاينة هي الذي تُعيد تحفيز الشعب العربي والشخصية العربية على المواجهة وهزيمة هذا الكيان السرطاني. صحيح أنّ حركة التاريخ بطيئة، لكنّها إذا ما توفرت القناعة التامّة لضرورة المواجهة والخروج من السبات الطويل للشعوب العربية، بعد أنْ كفرت بكلّ النخب وكلّ الأحزاب، وما يحدث في غزّة من حرب إبادةٍ لشعبنا العربي الفلسطيني، خير دليل، ولم يوقظ شعوبنا إلى الآن.





