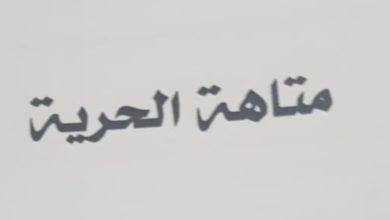قريبا صدور كتاب جديد للأكاديمي د. سعد كموني

قريبا صدور كتاب جديد للأكاديمي د. سعد كموني
كل العرب- خاص
يصدر قريبا عن “المركز الثقافي للكتاب” في الدار البيضاء. و قد جاء في مقدمته
مقدمة
ما هذا الذي أحدثته الجائحةُ ؟ حتى باتت الأسئلةُ تتفاقم وتزدحم في داخلي!
هل الله هو الذي يهلك البشر؟ وما الذي اقترفوه حتى يستحقوا هذا الهلاك؟
لم أعدْ أفهم، لماذا خلقهم، ولماذا يهلكهم، ولماذا يهيّىء لهم ظروفاً تودي بهم إلى التهلكة؟ ولماذا هيّأ للبعض أن يكونوا في منجاةٍ من الهلاك، ولم يجعل ذلك لآخرين؟
هل نفهم الكونَين فهماً مغلوطاً، كونَ الله وكوننا، والعلاقة بينهما؟
قد لا تكون هذه الأسئلة جديدة، بل ربما تكون عريقة، وتلحّ أكثر ما تلح في النكبات التي يبدو فيها المرء عاجزاً بإزائها، ولكنها مع عراقتها، أراها مسؤولةً عن توجيه التفكير من جديد في هذا الكون، وفي هذه الحياة. وأن نشحنَ عقولنا بطاقةٍ من خارج المتاح لها في أصل تكوينها لا أظنّه ينفعنا بشيء؛ فعقولنا تشكلت عبر آلاف السنين، بنظُمٍ تجعلنا دائما في حال خصومةٍ مع الكون، في الوقت الذي نكون فيه في حال رضىً وطمأنينةٍ مع العُلا؛ فالعُلا مصدر الغيث في كل الأحوال، نتقرب منها بالدعاء والابتهال والصلاة، كما ننقم على أنفسنا ونتهمها بالقصور في التقرّب عندما لا نرى العلا تتجاوب مع حاجاتنا.
لا أعتقد أن الوجهةَ التي تنهي الاضطراب المستحكمَ في عقولنا من هذه الجائحة، يمكن أن تكون خارج إطار النُّظم التي شكلتها. لذا؛ سأنطلقُ في التعامل مع هذه الأسئلة وغيرها على قاعدةٍ ثابتة راسخة مفادها الإيمان بالله الخالق(وهذا أمرٌ شخصيّ)، ولكنني منزعجٌ من كونه مُهلكاً لخلقه، سأحاول تفكيك هذه المسألة لعلّي أجدُ ما يُطمئن.
إنّ تصوراتنا عن الله هي بالحقيقة ليست تصوراتنا، إنما هي موروثة ومتراكمة وقد تداخلت في تكوينها تصوراتٌ متباعدة المنشأ أو متقاربة، ولا يمكننا أن نلغيها بجرّةِ قلم، أو بقرار يُتّخذ في محفلٍ ما، لكنّ الممكن هو تحليل هذه التصورات، وإعادة فهمها، بوسائط تحليلية ذكية ومرنة، تتجافى عن التعصّب وتترك الأبواب مفتوحةً وفق منهجيّة علمية قابلةٍ للتطور. وأعتقد أن هذه المهمّة من شأنها أن تفسح في المجال أمام هذه التصورات الموروثة كي تتزحزح، وتأخذ أبعاداً جديدة من المؤثرات التي تتركها تلك الوسائط التحليلية. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ العقل العربيّ لا يمكنه التخلص من تعثره المعاصر وتلعثمه أمام الفتوح العلميّة الكبرى ما لم يتخلص من تصوراته الموروثة والمتراكمة؛ إذْ من حقه أن يغامر وفق منهجية علمية جريئة ومرنة، أو يستجيب لمؤثر بعصف ذهني متفلتٍ من أي عقال معنوي أو عقديّ ليتمكن من تجاوز هذا التعثر والهامشية الحضاريّة.
يسهل السؤال :”لماذا الإهلاك”؟ غير أن الإجابة لا ينبغي أن تكون خاضعةً لرغبةٍ في النجاة من كلّ سوء، بل ينبغي أن تكون في سياق فهمٍ كلّيٍّ للوجود، أنا لا أريد أن أؤمن خوفاً وطمعًا؛ ولا أريد أن أرثَ إيماناً يربكني دائما بإزاء النظم الكونيّة التي مايزال أغلبها غامضاً؛ ولن يستمرّ شيءٌ في غموضه. ولا يمكنني أن أكون في هذا الكون كما لو أنني في سجنٍ شديد الانضباط، يتوعدني السجان الذي لا أراه عند كل شغبٍ فكريّ أو وجداني.
فهمٌ على هذه القاعدة الاستسلامية إنما هو انتحارٌ ذاتيّ غير مسوَّغ.
الله ليس سجاناً لمخلوقاته، والكون أيضاً ليس له نوايا عدوانية تجاه بعض غباره، والكوارثُ الكونيّة هي كوارث وفق رؤيتنا نحن فقط، فهي سلوك طبيعيٌّ، علينا أن نصغي جيدا للعلماء ومراكزهم البحثية لمعرفة طبيعة هذا السلوك الكونيّ، وفي كل الأحوال هي معرفة ليست نهائيّة ولا تتطلّبُ وثوقية حاسمة.
كذلك الحروب والفتن إنما هي مهلكةٌ، ولكنها ليست أدوات الله لإهلاكنا، بل هي أدوات النظم الاجتماعيّة على سطح هذا الكوكب، تلك النظم الواجبة لضمان أمن الاجتماع الإنساني، والتي يسعى الإنسان إلى بلوغها، وكلّما أنجز درجةً في فهم هذه النظم يتدخل بجبروته وفساده لإفساد حياته وحياة الآخرين، وهكذا إلى الأبد. ستبقى النظم صارمة وتسحق من يعاندها سواء كانت نظما كونية أو اجتماعية أو حيوانية أو نباتية…..
تصوراتنا عن الله نابعة من كوننا بشراً على علاقة مع الكون؛ فالله ملكٌ أقوى وأعظم من كل الملوك ومن كل شيوخ القبائل مجتمعين، وأقوى من كل الأرض والسماوات، وأقوى من كل أجهزة السلط المحلية والدولية…. إذن، أنا لم أتصوّر الله إلا من خلال معايشتي للقوى العظمى في الاجتماع البشري أو الحيواني، فهل ما زالت القوى العظمى هي نفسها؟ ألم تتغير منذ مئات السنين؟ ما يعني أنني أعرف الله بتصورات سابقة على وجودي الفرديّ؛ فهل يصح أنْ أرث تلك التصورات حتى يصحّ إيماني.
القوى العظمى اليوم هي قوى المعرفة المتجددة و المتناسلة، معرفة النظم الكونيّة، ومعرفة النظم الخاصة بكل فرد، سواء كانت جسدية أو نفسية، ومعرفة قدرات الإنسان فردا وجماعة بإزاء الجسد والنفس والاجتماع والكون. كل هذه يجب أن تكون منطلقًا لتجديد تصوراتنا عن الله. عندها يجب أن يتغير فهمنا للإهلاك الإلهي، وتعديل سلوكنا بما يقتضي الفهم الجديد.
أفترض أنّ الإهلاك الإلهي لن يكون حتمياً، ويمكن تلافيه؛ إذا فهمنا الله تأسيساً على معرفتنا الجديدة المتجدّدة التي تهيّأت لنا في سعيٍ دؤوب لفهم النظم الكونية والإنسانية جسداً ونفساً، هيئة ومعنى؛ فلا نقرب سيرورة النظم إلا على بينةٍ من الأمر؛ فلا يهلكنا المناخ أو الأوبئة أو الجفاف أو…… ولا نقرب صيرورة النظم إلا على هدىً من الأمر فلا يهلكنا الاحتباس الحراري أو الانبعاثات الكربونية أو التسرب النووي….. أو النزق القياديّ.
وأفترض أن القرآن الكريم أتاح للمتلقي أن يفهمه كلما تلقاه. وعليه أن يعتد لذلك العتادَ المناسب لقدراته الذهنية ومعرفته وانتمائه إلى العصر الذي فيه. وأن يتوسل الوسائل المسبارية الملائمة، فلا يجوز الآن بعد هذا التطور الكبير في معاينة النصوص واستنطاقها، أن يصرّ على ما وصل إليه من إنجازات المذاهب.
لإثبات ذلك سأعمد إلى الآيات القرآنية ذات الصلة، وأتعامل معها بوصفها شبكاتٍ علاميّةً تمَّ إنتاجُها وِفاق أنظمةِ إنتاج المعنى في اللغة العربيّة، مع مراعاة أساليب القول في هذه اللغة زمن التنزّل.
طبعاً؛ لن أفتري على الآيات القرآنية التي تنطوي على إسناد فعل الإهلاك إلى الله، فأزيد أو أنقص منها، ولكنني سأتجاهل ما قاله المفسرون بإزائها، لكونهم تعاملوا معها تحت تأثير أسئلةٍ أخرى مغايرة لأسئلتي. أتعامل مع الآيات الكريمات بوصفها أحداثاً لسانية، ترتبت على نحوٍ مخصوص لأداء معنى لا يمكن أداؤه بنحو آخر، أتوسل المنهج الأسلوبي التعبيري في معاينتها، ومستفيداً مما تتيحه النظرية السياقية الدلالية بهدف استنطاقها، ومستثمراً ثقافتي الخاصة بوصفي متلقياً معنياً بهذه الأحداث اللسانية؛ لعلي أقف على مدلولات يصح السكوت عليها.
هل خلقَ الله الكون والإنسانَ ليخلقوا أنظمة بقائهم و استمرارِهم، أم أنه خلق تلك الأنظمة وعليهم أن يفهموها؟ وأيّ اختلال في النظام، هو ما سيؤدي حتماً إلى كارثة على البقاء والاستمرار؟؟؟ ويتحمّلُ المخلوقُ مسؤوليةَ ذلك؟؟
ما نلحظه، أن الكون له أنظمته ليبقى ويستمر، ولا أعتقدُ أن هذا الكون هو الذي أنتجَ أنظمتَه، وكذلك الإنسان كان وله نظامه الدوريّ، والخلوي، والجيني، والنووي، لم يخلق الإنسانُ شيئاً من هذا، ولا حجّةَ في ذلك لمن يقولُ إنّ الزمن المتمادي، بوصفه حاملاً للأحداث، سيوصلنا إلى إنسان ينتجه إنسانٌ في المختبر، فلا تعود هناك حاجةٌ لنظام الحمل والولادة المعهود مذ كان الإنسان، أو أيُّ مخلوق؛ أقول: لا حجةَ لمن يقول هذا، لأنّ العلماء لم يخلقوا شيئاً ولن، ولا ينبغي لهم، بل كل ما يجري إنما هو اكتشاف، وهذا ليس بالأمر البسيط، بل هو بالغ التعقيد ليس نهائيًّا وينمو باطّراد. ما يكتشفونه قد يكون خطراً على الأنظمة وقد لا يكون، وهنا تبدأ مسؤولية الإنسان في أن يعرف وزن ما يكتشف، أي قيمتَه، فالله يقول في سورة الحِجر ﴿ وَأَنۢبَتۡنَا فِیهَا مِن كُلِّ شَیۡءࣲ مَّوۡزُونࣲ﴾ والذي يمنح الشيءَ وزنه، هو نوعه، وثقلُه النوعي، ووظيفته. فكل شيءٍ له وزنه يعني له اسمه ووظيفته. صحيحٌ أننا نحن الذين نسميه، إلا أنّ الصحيحَ أيضاً هو أنّ هذه التسمية تابعة لمعرفتنا بالوظيفة، وربما نكون قد عرفنا الوظيفةَ خطأً، أو أننا أردنا له وظيفةً أخرى.
أن يزودنا العلمُ بمعلوماتٍ مفادها أنّ الإنسان هو غبرة من الغبار الذرّي؛ سيجعلنا نعيد النظرَ في فهمنا للمركّب الماديّ، ولكن المسألةَ ــــ هنا ــــ لا يغلب فيها النظر بالمكوّنات الماديّة، بل تتعلّق بالنظرِ إلى الإنسانِ بوصفه كائناً يعي موقعه في هذا الكون وهو الذي يسمي أجزاءه تأسيساً على فهمه لها، وهذا الفهم يتأتّى من رؤيته الخاصّة بوصفه كائناً فرداً، أو بوصفه كائنا اجتماعياً، وتحكم هذه الرؤيةَ ثنائيّةٌ ضدّية حادّة، طرفاها الخوف والطمأنينة اللذان يشكّلان مظهراً ماديّاً أو معنوياً للمواجهة الأزليّة مع الموت الذي لولاه ما كان من ضرورةٍ لأي تفكير أو حلم أو ندم. وكلما تَغيّرَت الفهوم تتغيّرُ طرائقُ النظر لتصبح إمكانية تلافي الموت أكبر؛ وهذا ما يحتّم اكتشاف وزنه، وكلِّ شيءٍ موزون.
إذن؛ الله الخالق، ﴿ وضع الميزان﴾؛ مِفْعال الوزن دلالةً على الآلة المستعملة في إنجازه، وإذا فهمنا أنّه رمز للعدل فلا يجوز أن يكون العدل فقط في البيع والشراء وبالمعاملات، إنما هو في كلّ شيء، والآلةُ الموضوعةُ لهذا الأمر هي العقل الذي يُلزَم الإنسانُ باعتماده في تعيين الحق لكل ذي حق في الوجود جماداً كان أو حيوانا، فالمطلوب أن لا يطغى الإنسان في الميزان فالإنسان ملزمٌ طالما أنه موزونٌ، وهذا يحتّم عليه أن يعرف نظام كلّ شيءٍ. الله خلق الكون وخلق الإنسان ووضع الميزان، فكيف يكون أنّ الله يهلك الإنسان ولا يختلّ الميزان؟ وما الذي يؤدي إلى اختلال الميزان بوصفه آلةً للوزن، والله يقول: ﴿وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾؟
توزعت مباحث هذا العمل تحت ستة عناوين هي على التوالي:
- الذنوب المهلكة هي مخالَفة النواميس
- العواقب الحتمية لمخالفة الناموس
- الإهلاك الإلهي ناموس غير اعتباطيّ
- البشارة والنذارة والإهلاك
- مصارع الأمم ومهالك الحضارات
- البطر والفساد مهالك أهل القرى
أرجو أن يكون ما كتبته من أسباب تحريض العقول العربية على أدائها، فتنهض نحو معتقداتها بهدف إصلاحها، إذ لا خلاص لنا من التعثر الحضاري إلا بالإصلاح العقدي.